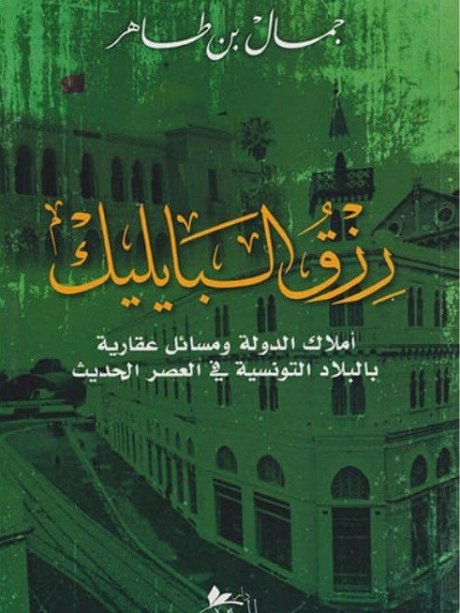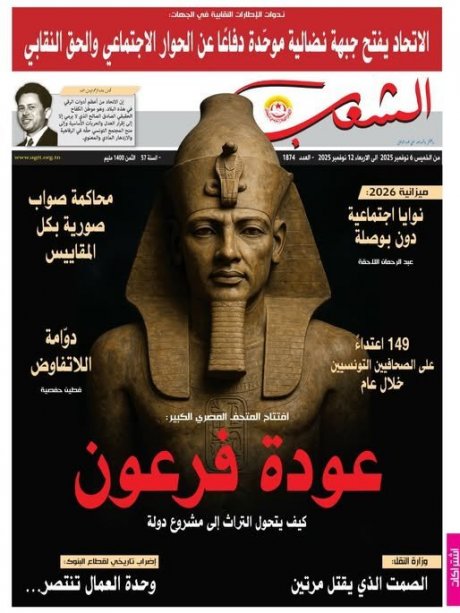" بمناسبة معرض تونس الدولي للكتاب : الشاعر محمد العربي يكتب عن " الجامعيين وتدمير الثقافة التونسية

الشعب نيوز / ناجح مبارك - إن الهيمنة الرمزية التي يمارسها بعض الجامعيين على الفضاء الثقافي لا تقوم على الإبداع أو التجديد بقدر ما تقوم على شبكة من العلاقات والمصالح والتراتيب التي بُنيت عبر عقود من التحالفات بين الجامعة والسلطة، سواء كانت سلطة الدولة أو سلطة النخب الثقافية. هكذا يصبح الأستاذ الجامعي "مرجعية لا تُناقش"، لا لأن فكره أحدث قطيعة معرفية أو قدّم مشروعًا ثقافيًا جذريًا، بل لأنه ببساطة منتمٍ إلى نادي مغلق، يحرس أعضاؤه بوابة الثقافة الوطنية.
في ظل هذا الإقطاع الرمزي، تتحول الثقافة إلى مجال محفوظ لأقلية تتحكم في مفاتيح التقدير والاعتراف. تُمنح الجوائز للأصدقاء، وتُوجَّه الدعوات في الندوات حسب الولاءات، وتُمارس الرقابة الناعمة على الأصوات "المزعجة"، لا بالقمع المباشر بل بالتجاهل والتهميش.
هذا الوضع يخلق ثقافة مشلولة، تدور في حلقة مفرغة من التكرار والتملق المتبادل، وتفقد صلتها بما يجري في الشارع، في الأحياء الشعبية، في الجامعات المهمشة، وفي مدن الداخل. الأصوات الجديدة تُطرد بهدوء من المشهد، ويُطلب منها إما الخضوع للتراتبية أو البقاء على الهامش.
إن ما نشهده اليوم هو أزمة ثقافية بامتياز، جوهرها احتكار النخب الجامعية للخطاب الثقافي وتحوّله إلى سلعة نخبوية، لا تصل إلا لمن يتقن "كود" الحديث الأكاديمي، أو يمرّ عبر مسارات التطبيع مع المنظومة القائمة. أما البقية، فمكانهم في الظل، أو في الهامش الرقمي حيث يحاولون أن يصنعوا ثقافتهم البديلة دون دعم أو اعتراف.
لقد آن الأوان أن يُفتح النقاش حول دور الجامعة والجامعيين في تشكيل الوعي الجماعي، لا من موقع التقديس، بل من موقع المحاسبة والنقد. فليس كل من نال شهادة دكتوراه هو مفكر، وليس كل من ارتقى في السلم الأكاديمي هو مثقف عضوي أو مصلح اجتماعي.
نحن لا نعادي الجامعيين ولا نحمل ضغينة لأصحاب الفكر والبحث. على العكس، نرحب بكل نَفَس إبداعي صادق، مهما كان مصدره، ونكنّ التقدير لكل من وهب حياته للمعرفة الحقيقية، تلك التي تُضيء الواقع بدل أن تهرب منه. لكن ما نواجهه اليوم في تونس، وفي أكثر من مشهد ثقافي وأكاديمي، هو تكلس نخبوي ناتج عن عُقم إبداعي مزمن.
إن من يستولي على المنابر لا يفعل ذلك لأن لديه ما يقول، بل لأنه لم يعد قادرًا على الإبداع، فاستعاض عن ذلك بالهيمنة. حين تجفّ القريحة، وتنضب الأفكار، ولا يعود لدى الإنسان ما يضيفه إلى العالم، يبدأ في التشبث بالمناصب، والمكانة، والعناوين الرنانة. وتُصبح "اللجنة" أو "الندوة" أو "المهرجان" ملاذًا يحفظ له رمزيته، ويخفي عجزه خلف بريق الكراسي الأمامية.
هذا العقم لا يولد فجأة. هو نتاج مسار طويل من الكسل الفكري، والمحاباة داخل الأوساط الجامعية، والخضوع لمقاييس الترقية الشكلية التي تفضل الكمّ على الكيف، والولاء على الجرأة. في النهاية، نجد أنفسنا أمام جيل من "الأساتذة الكبار" الذين لم يكتبوا نصًا مزلزلًا منذ سنوات، ولم يطرحوا سؤالًا مقلقًا، بل يعيشون على مجد محاضرة قديمة أو كتاب نُسي بين رفوف المكتبات.
وما يزيد الصورة قتامة أن هذا العجز المعرفي يترافق مع نزعة نفعية. فالكثير منهم، وهم يمسكون بخيوط الفضاء الثقافي، لا يسعون فقط للاعتراف أو الاحترام، بل أيضًا للمكاسب الرمزية والمادية: عضوية لجان، الدعم، دعوات السفر، مداخلات مدفوعة، تواجد دائم في المشهد الإعلامي، وحتى مقاعد خلف الستار في صنع القرار الثقافي.
في وجه هذا الوضع، كيف يمكن أن ينهض الإبداع؟ كيف يمكن لصوت جديد أن يُسمع وسط هذا الصخب الفارغ؟ كيف لشاب يحمل فكرة، أو كاتبة تكتب من قلب الهامش، أن تجد لنفسها مكانًا في مشهد تحتكره أسماء بعينها، وتضبط إيقاعه نخبة قررت أن تسجن الثقافة في صورة تُرضيها هي فقط؟
ليس الهدف إسقاط كل الجامعيين في سلة واحدة – فثمة أصوات شريفة ومضيئة داخل هذا الوسط – ولكن الهدف هو كشف آليات التسلط الرمزي والانغلاق المعرفي التي جعلت من الثقافة التونسية حكرًا على نخبة صغيرة، تُعيد إنتاج ذاتها، وتُقصي غيرها، وتُحافظ على مواقعها بكل ما أوتيت من قوة.
..... يتبع